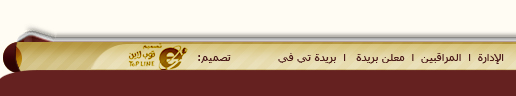[align=center]
كلمتانِ مُتجانستانِ منْ حيثُ إيقاعُهما الصّوتيِ، مختلفتانِ منْ حيثُ المصدرُ والدّلالةُ.
تقولُ: "هذا هرطِيقٌ" على زِنةِ (برمِيل) بمعنى: منطلقٌ. وكأنّي بزنجيّ من أولئكَ الزّنوجِ الذينَ تنفّجتْ مناخرُهم -فتبارك اللهُ أحسنُ الخالقينَ- وهو يقول لمن تحتَ يدهِ في معركةٍ من معاركهمْ مع أفرادِ القبيلةِ المتاخمةِ لهم: "هرّوا ياجماعة عليهم!" أي: انطلقوا، وهو المقطع الأوّل من كلمة (هر- طق)، ثمّ يُلْحِقُ هذا السيّدُ الأسودُ –وصفًا لا انتقاصًا معاذ الرّبِ بذكرِ لونِهِ، إذ الفارقُ بينَ البياضِ والسّوادِ الدرجةُ في حُلْكةِ اللونِ وتفتُّحهِ-: "أكولُ لكم: هرّوا عليهم! تقُّوهمْ!" أي (طُقُّوهم) بمعنى: اضربوهم، وهنا الجمع بين مقطعي كلمةِ ( هر – طق). فلله ما أحلى أن يبينَ هذا الأعجميُّ في مثل هذا الموقفِ شديدِ الوطأةِ، ليسبِكَ مثل هذه السّبيكةِ، وينحتَ مثل هذا المصطلحِ، إذ المؤدّى النهائيُّ للهرطقةِ هو (انطلاقُ الضّربِ) بأنواعه الحسيّةُ والمعنويّةُ.
ومن هنا قولي بعدمِ صحةِ رأيِ منْ ذهبَ إلى أنّ الهرطقةَ جمعتْ بين كلمتينِ صِنوينِ هما (هِرْ) و(قِطْ)، بقلبٍ مكانيٍ للمتأخّرةِ، حيثُ تقديمُ القافِ على الطّاءِ، إذْ يكونُ المعنى -على هذا الرأيِ- القطُّ الحيوانُ النمريُّ المعروفُ، ولا معنى منَ التكرارِ هنا سوى تأكيدِ الوصفِ بالقطيّةِ لا غيرَ, وهو كما يقولُ البلاغيون (جمع بلاغيٍ من البُلغةِ: كثرةُ المالِ على سبيل التريقةِ من فاقةِ المثقفينَ، ومن البلوغِ أي: الوصول باللغةِ إلى المخاطبِ واستلابهِ): هذا لغوٌ وحشوٌ في الكلام!
وأمّا كلمةُ ( الطقطقةِ) فمأخوذةٌ من طقّ الشيءَ، أي: أحدثَ فيه حركةً واضطرابًا، يقولُ أحدُهمْ بعدَ سؤالٍ لقريبٍ أو صديقٍ عنْ حالهِ: أنا بخيرٍ، وأُطقطِقُ في هذه الحياةِ. ومقصودُ كلامهِ أنّه يسعى في طلبِ الرزّق، فهو يطقُّ أي: يطرقُ أبوابَهُ، حسّاً بهيامهِ في ملكوتِ الأرضِ، ومعنىً بدعائهِ الرّبَ. ويندرجُ قول الشّاعر تحت هذا البابِ حين أنشدَ بعد تنهيدةٍ حارّةٍ صعّدهَا إلى حيثُ لا يدري -بعد سؤالِ متطفّلٍ عن حاله ومآلهِ-:
أتسألُ عنْ حاليْ؟ فإنّي أُطقْطِقُ
أجولُ الفلاْ غربًا ومن ثمّ أُشرِقُ
فلا تسْـألنّـي اليومَ شيئاً فإنّني
إذا لمْ تبتعدْ عنّي فسوفَ أُهرطِقُ
ومعنى قول الشّاعرِ في شطرهِ الأخيرِ، يؤكّدُ ما ذهبنا إليهِ سابقًا في معنى الهرطقةِ، إذِ المعنى: إنْ لم تكفَّ عن سؤالي أيّها المتطفّلُ فسوفَ أنطلقُ عليك ضربًا.
هذا ماوُفّقنا إليهِ من بيانِ دلالةِ هاتينِ الكلمتينِ المتقاربتين صوتًا، المتباعدتينِ فهمًا، الموصولتين نتيجةً، إذ قد تؤدّي الطقطقةُ إلى الهرطقةِ، كفانا الله شرّ الشرِ، بتقريبِ خير الطقطقةِ، وإبعادِ شرِ الهرطقةِ، إذ ليستْ كلها شراً، فقد نحتاجُ إليها في يومٍ هو أشدُّ حلكةً في سوادهِ من سوادِ الزنجيّ الآنفِ الذكرِ، لنوسعَ منْ نختلفُ معهُ شتمًا وضربًا، بعد أنْ كانَ الأجدادُ لايكتفونَ بهذا، بل يعمدونَ إلى الإغارةِ والسّفكِ. [/align]