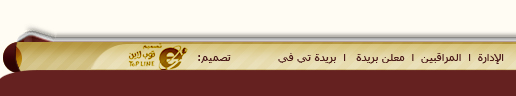غرفة صغيرة أشبه بعلبة أعواد الكبريت، محكمة الإغلاق من الداخل، ومنفذ وحيد للخروج هو الباب الخشبي الضخم، رغم الإحكام الشديد إلا أن الأصوات لا زالت تنفذ من خلاله، وهذا ما زاد الضجر عند ليلى، فهي لطالما تصبو إلى الراحة والسكون، بعيداً عن هذا الجو المزعج الذي لم يجلب لها سوى اليأس والكدر، لذلك بدا عليها الوهن والضعف فاستسلمت له مباشرة لترمي بقلمها على المكتب، واتجهت نحو سريرها وألقت بثقلها عليه لتدخل بذلك عالم الأحلام الوردي، عالم الجمال والهدوء ، بعيداً عن مكائن الدبابات وقعر السلاح وصراخ البشر.
إلا أنه لا بد من أمر مؤذي ينهي رحلتها الجميلة إلى ذلك العالم، وتعود مرة أخرى إلى قوقعتها، أدركت ليلى الصباح رغم أنها حبست خيوطه عن غرفتها البائسة، لأنها ببساطة لا تطيق النظر إلى تلك الشمس القاتلة، التي لا تأتي إلا بيوم دموي جديد، يكسي السماء بالدخان، ويخنق الأزهار والأشجار، فتموت بذلك نكهة الصباح الوردي على أطباق خمور العدو وسجائرهم النتنة.
انتكست ليلى من جديد، وزادت بؤبؤة عيّنيها في الاتساع، لتصارع الأرض بتفكيرها الأليم، والسؤال المرير، إلى متى سأظل هكذا؟! حابسة نفسي بين أوهام الدهر؟! منتظرة ذلك اليوم المخّضر على ضفاف النهر؟!
هل ستكون نهايتي كأصحاب الأندلس، أصبر النفس على الجلد، حتى تأتي الإغاثة فأغنم مثلهم بحرق الكتب وزهق البشر!!
ارتسمت بعد تفكير طويل ابتسامة مشرقة على وجه ليلى، وأخذت تصف الثياب والكتب في حقيبتها الذهبية، ثم استدارة نحو البوابة الضخمة لتواجهها وتدفعها بكل ما أتيت من قوة، رغم أنها على علم بأن المواجهة الحقيقة في الخارج أشد من ذلك، حاولت ليلى ولا تزال زحزحت هذه البوابة الضخمة، حتى استطاعت دفعها قليلاً لتكوّن ثغرة صغيرة استطاعت العبور من خلالها، فانطلقت نحو مصيرها المحتّم، ذلك المصير الذي تشرق عليه كل صباح بعزف الرصاص ولون الدماء، ورائحة الريحان تهب من أجساد الشهداء ، لتسطر ليلى بقلمها المجاهد هذه المشاهد، وتعلو في نفسها الشموخ والعزة لكونها جزء من هذه الأرض المجاهدة.